ويجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه ، لكن لا يجوز له أن يعتدي في دعائه ، وخير من الدعاء العفو : والمسامحة .
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :
( يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة ، فينادي منادٍ على رؤوس الأولين والآخرين : هذا فلان بن فلانٍ ، من كان له حقٌ فليأت إلى حقّه ، فتفرح المرأة أن يكون لها الحقّ على أبيها ، أو على ابنها ، أو على أخيها ، أو على زوجها ، ثم قرأ ابن مسعود : ( فَلَاْ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَاْ يَتَسَاءَلُون) المؤمنون/101 ، فيغفر الله تبارك وتعالى من حقّه ما شاء ، ولا يغفر من حقوق الناس شيئًا ) رواه الطبري في تفسيره (5/90) .
وقد أرخص الله سبحانه وتعالى للمظلوم أن ينتصر ممن ظلمه في الدنيا ، وذلك بما يقدر عليه ، من غير تعدٍّ ولا تجاوزٍ ولا ظلم .
قال الله تعالى : ( لَاْ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ) النساء/148 .
قال ابن كثير في "التفسير" (1/572) :
" قال ابن عباسٍ في الآية : يقول : لا يحب الله أن يدعو أحدٌ على أحدٍ ، إلا أن يكون مظلومًا ، فإنّه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه ، وذلك قوله : ( إِلّا مَنْ ظُلِمَ ) ، وإن صبر فهو خيرٌ له " انتهى .
وقال تعالى : ( وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيْلٍ ، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَىْ الّذِيْنَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِيْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ ، أُوْلئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ) الشورى/41-42 .
وقال تعالى : ( وَالَّذِيْنَ إِذَاْ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ) الشورى/39 .
وقد جاء عن بعض الصحابة دعاؤهم على من ظلمهم :
فلما اتهم رجلٌ من أهل الكوفة سعدَ بن أبي وقاص رضي الله عنه بما هو بريء منه , قال سعدٌ : ( أما واللّه لأدْعونّ بثلاْثٍ : اللّهمّ إنْ كان عبْدك هذا كاذبًا قام رياءً وسمعةً ، فأطلْ عمره ، وأَطِلْ فقْرَه ، وعرّضه للْفتن . فكان الرجل يقول بعد ذلك : شيخٌ مفْتونٌ أصابتْني دعْوة سعْدٍ ) رواه البخاري (755) ومسلم مختصرا (453) .
وعن محمد بن زيد عن سعيد بن زيْدٍ رضي الله عنه أنّ أروى ( اسم امرأة ) خاصمتْه في بعْض داره ، فقال : دعوها وإيّاها ، فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أخذ شبْرًا من الأرض بغيْر حقّه طوّقه في سبع أرضين يوْم القيامة ) ، اللهمّ إن كانت كاذبةً فأعم بصرها , واجعلْ قبرها في دارها ، قال : فرأيتها عمياء تلتمس الجدر ، تقول : أصابتني دعوة سعيد بن زيدٍ ، فبينما هي تمشي في الدّار ، مرّت على بئرٍ في الدّار فوقعتْ فيها فكانت قبْرها . رواه مسلم (1610) .
قال النووي في "شرح مسلم" (11/50) :
" وفي حديث سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه جواز الدعاء على الظالم " انتهى .
وإذا دعا المظلوم على من ظلمه ، فلا يتعدَّ في الدعاء ، ولا يتجاوزْ ما شرعه الله له .
قال الحسن البصري :
( لا يدع عليه ، وليقل : اللهم أعنّي عليه ، واستخرج حقّي منه ) .
وفي روايةٍ عنه قال : ( قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه ، من غير أن يعتدي عليه ) انتهى .
"تفسير ابن كثير" (1/572) .
وخير ما يدعو به المظلوم ، هو ما جاء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم .
فعن جابرٍ رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الَّلهُمّ أَصْلِحْ لِيْ سَمْعِي وَبَصَرِيْ ، وَاجْعَلْهُمَا الوَارِثَيْنِ مِنّي ، وَانصُرنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي ، وَأَرِنِي مِنْهُ ثَأْرِي ) . رواه البخاري في الأدب المفرد (1/226) ، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قلّما كان يقوم من مجلسٍ حتّى يدْعو بهؤلاء الدّعوات لأصحابه : ( الّلهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ . . . واجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىْ مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَىْ مَنْ عَادَانَا . .) رواه الترمذي (3502) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وخيرٌ من ذلك كله : العفو ، وترك أمر الظالم له سبحانه وتعالى يوم القيامة ، وذلك أنّ من عفا عن حقّه في الدنيا ، أخذه وافرًا في الآخرة ، وأراح قلبه من شوائب الحقد والغيظ .
وقد بوّب البخاريّ في صحيحه (2/864) :
" باب عفو المظلوم لقوله تعالى : ( إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ) النساء/149 . ( وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ) الشورى/40 . ( وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ) الشورى/43 " انتهى .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( يَا عُقبَةَ بنَ عَامِر : صِلْ مَنْ قَطَعَكَ ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ ، وَاعْفُ عَمَّن ظَلَمَكَ ) رواه أحمد (4/158) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"(891) .
















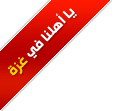








 العرض العادي
العرض العادي

